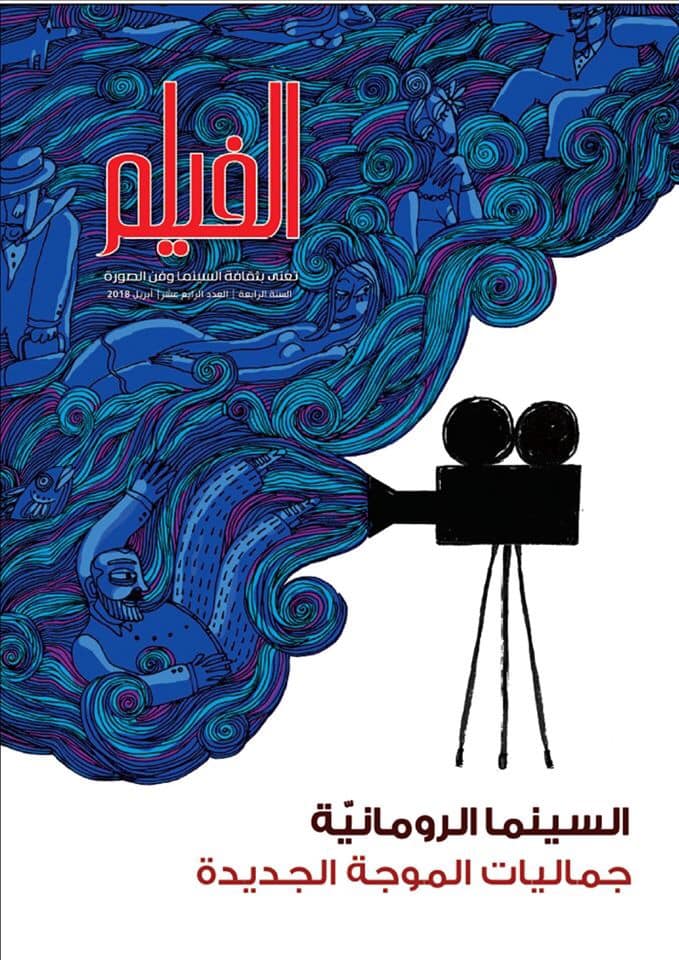
اختيار موضوع السينما الرومانية الجديدة لعدد كامل من مجلة سينمائية مصرية هيبدو غريب وعجيب من وجهة نظر الناس اللي شغّالة في مطبخ السوق السينمائي المصري، اللي معظمهم ماسمعوش عن السينما الرومانية ولا إنها شكّلت تيار جمالي جديد ولا إن رومانيا عندها سينما أصلاً، لأن ثقافتهم السينمائية مابتخرجش برة إطار تجاري مصري أو هوليوودي، وماحدّش فيهم مهتم يسمع عن سينمات مش تجارية في دول هامشية زي رومانيا. ولكن بالنسبة للناس اللي شغّالين في مجلة الفيلم، اختيار السينما الرومانية الجديدة اختيار طبيعي بما إنها نموذج محتمل للإجابة على سؤال بسيط بيشغل أي صانع أو ناقد أو عالم عايز يطوّر سينما برة معايير السوق التجاري، وهو: إشمعنى هناك ومش هنا؟
إشمعنى فيه مجموعة سينمائيين جدد في رومانيا قدروا ينتجوا سينما جديدة ومثيرة وإنسانية بإمكانيات مادية ضعيفة، وفي المقابل مافيش مجموعة زييهم في مصر؟ إشمعنى السينما الإيرانية قادرة تنتج عباس كيارستمي ومحسن مخملباف وأصغر فرهادي، اللي حققوا شهرة عالمية في المهرجانات الكبيرة والصغيرة، ومافيش مخرج عنده نفس الشهرة والسمعة في مصر؟ إشمعنى الرومانيين والإيرانيين قادرين يحققوا النجاح ده وإحنا مش قادرين؟
لازم نلاحظ أولاً إن السؤال ده مالوش جواب قومجي بسيط، بمعنى إن مافيش حاجة جوهرية وأصيلة جوة الشعب الروماني أو الشعب الإيراني أو الشعب المصري بتخلليهم أحسن في صناعة السينما من الثانيين، بدليل إن مافيش سينما من السينمات دي كانت جامدة وعظيمة ومالهاش حل طول عمرها، وكان ممكن المواطن الروماني والإيراني يحس إن مافيش أمل في تطوّر مستوى السينما الجمالي والصناعي والفكري لغاية ما المستوى ده اتطوّر بالفعل. بالتالي ظهور سينما رومانية أو إيرانية أو مصرية جديدة دايماً وارد حسب الظروف التاريخية والضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتاحة، ومافيش حد أجمد من الثاني لمجرد إنه اتولد في بلد معيّنة.
ثانياً لازم نلاحظ إن سؤال “إشمعنى هناك ومش هنا” أساسي في وجدان السينما من بداياتها. السينما كانت دايماً صناعة عالمية بطبعها، من ساعة ما الإخوان لوميير سافروا حولين العالم (ووقفوا في مصر على الطريق) عشان يستعرضوا التكنولوجيا السينمائية الجديدة لغاية النهاردة وصناع السينما في العالم كله بقوا يتفرجوا على شغل بعض سواء كانوا في أمريكا أو أوروبا أو آسيا أو أفريقيا. السينمائيين في جميع أنحاء العالم دايماً واعيين بوجود سينمات ثانية في بلاد ثانية، ودايماً عايزين يطوّروا من حرفتهم وصنعتهم وفنهم بإنهم يشوفوا وينقشوا ويستلفوا من الصناعات الثانية دي.
بالتالي سؤال “إشمعنى هناك ومش هنا” مهم بالنسبة للسينمائيين التجاريين المصريين زي ما هو مهم بالنسبة للسينمائيين اللي بيحاولوا ينتجوا سينما ثانية بجماليات ثانية. بينما بعض التجاريين بيقارنوا نفسهم بالسينما الهوليوودية مثلاً، وبيفتخروا بإنهم يصنعوا أفلام أكشن أو ساسبنس “زي الأفلام الأمريكانية بالضبط”، الصناع اللي رافضين المبدأ التجاري من أساسه بيحاولوا يقارنوا نفسهم بسينمات ثانية زي في السينما الرومانية والإيرانية مثلاً. يعني الإطلاع على العالم أساسي في جميع صناعات السينما، والفرق الرئيسي بين صناعات مركزية زي هوليوود وبوليوود وصناعات أصغر زي مصر ورومانيا متحدد حسب نوع الإطلاع على العالم ومفهوم “العالم” اللي بيتضمنه.
في الصناعة التجارية المصرية مثلاً، نوع الإطلاع الرئيسي عبارة عن محاولة لحاق دائمة بأحدث (وأغلى) التكنولوجيات السينمائية من ناحية، واقتباس الأفلام التجارية الأمريكية الناجحة من ناحية ثانية. في الحالتين، مفهوم “العالمية” بيفترض إن العالم متمركز حولين شركات كبرى في أوروبا وأمريكا، والصناعة المصرية لازم تجري وراء الشركات دي عشان إحنا دايماً “متأخرين”. الإحساس بالتأخر ده بيقوّي هيمنة الصناعات المركزية الأوروبية والأمريكية على السينما التجارية، لأنه بيفترض إن مافيش سينما كويسة ممكن تطلع من مصر إلا بتنفيذ نفس الخطوات اللي نفذّتها الصناعات دي عشان تكبّر نفسها.
في البلاد الصناعية الصغرى، فيه تيارات نقدية بتعترض بقوة على “تقليد” الصناعات المركزية في أوروبا وأمريكا، وبشكل أخص الصناعة الأمريكية التجارية. في حالة مصر، النقد ده متاح من أول كتاب المخرج والفنان كامل التلمساني، “سفير أمريكا بالألوان الطبيعية”، اللي اتنشر سنة 1957، لغاية الاتهامات بال”سرقة” من الأفلام الأجنبية الموجهة ضد الصناعة المصرية الحالية في الصحافة. من أول نقد التلمساني ضد دور الأفلام الأمريكية الإمبريالي لغاية النقد الساذج ضد “السرقة” من الأفلام الأجنبية النهاردة، الناقد الأصيل لازم يقول إن السينما الأصيلة مش ممكن تنقش قصص ولا مشاهد ولا حتى لقطات من هنا وهناك مجرد عشان تبسط الجماهير. السينما الأصيلة هي اللي بترفض تقليد الأنماط الأجنبية وبتحاول تنمّي الوعي الوطني وسط الفنانين والشعب.
الرؤية دي لها وجاهة بمنطق إن اقتباس الأفلام الأجنبية بدون الاعتراف بعملية الاقتباس نفسها بقى شيء منتشر في مصر، وبالتالي المتفرج اللي شاف أفلام أجنبية كثيرة يقدر يشوف التشابهات الفاضحة بين أفلام هنا وهناك ويحس برخص الخدعة. ولكن الواحد لازم يفتكر إن أكبر المخرجين في العالم كله، وفي مصر تحديداً، دايماً بيقتبسوا قصص ومشاهد وتيمات من سينمات أخرى، لأن مافيش سينما في العالم نشأت من نفسها لنفسها في نطاق قومي منعزل. حتى المخرجين اللي بنعتبرهم أساتذتنا زي يوسف شاهين ومحمد خان وداوود عبد السيد دايماً بينقشوا من سينمات ثانية، ولولا النقش – أو “السرقة” زي ما بيسميها البعض – ماكنّاش هنعترف بيهم كمخرجين كبار.
إذن الاقتباس تقنية فنية أساسية في جميع صناعات السينما في العالم، بما في ذلك في مصر. من فقر التفكير السائد عن السينما إن صحفيين ونقاد سينمائيين كثار بيعتبروا إن أي نوع من الاقتباس عبارة عن “سرقة”، أو بشكل أدق، أي نوع اقتباس مش معترف به في الأوساط الثقافية الرسمية زي تحويل الروايات والمسرحيات الفرنساوية والعربية الكلاسيكية إلى الشاشة. في الواقع، الاتهام بالسرقة بيصرف النظر عن المرونة الإبداعية اللي بتخللي أي صانع سينما ينقل قصص ومشاهد وإضائات وكادرات من سياق جمالي وتاريخي معيّن لسياق مختلف تماماً، سواء كان الاقتباس باين في فيلم مالوش وزن زي “حلاوة روح” المقتبس عن “مالينا”، أو فيلم مقدّر زي ال”كيت كات” اللي ناقش مشاهد كثيرة من أفلام لوكينو فيسكونتي وفيتوريو دي سيكا.
إذن النقد المعتاد ضد الأفلام اللي “بتسرق” من أفلام أجنبية بيفترض حاجتين غير دقيقة: أولاً إن السينما ممكن تتصنع من غير تأثيرات عالمية، وده مستحيل بما إن السينما في أساسها فن عالمي، وثانياً إن علاقة التقدم والتأخر في صناعة السينما مابتتغيّرش عبر التاريخ، وبتفضل الصناعات الكبرى دايماً أحسن من الصناعات الصغرى – وهوليوود النيرة أحسن من مصر الظلمات. الافتراض الثاني ده يمكن يكون جاي من إحساس تاريخي عام بالتأخر عند بعض المصريين، إحساس نشأ من أول الاستعمار لغاية النهاردة. فيه إحساس إن “هناك” دايماً أحسن من “هنا”، لأن هم متقدمين وإحنا متخلفين، والمشكلة فينا وفي وعينا مش في الظروف التاريخية اللي بتحكمنا.
الإحساس بالاستعمار الفكري والثقافي ده ما اختفاش مع نهاية الاستعمار الرسمي، لأنه إحساس أساسي حتى في النقد القومي للاستعمار اللي بقى منتشر بعد ثورة 52. مشروع التحرر القومي ماحررش المواطن من فكرة إن مصر لازم تبقى زي أوروبا وأمريكا، مش بس عشان البلاد المركزية دي مازالت نماذج التقدم الحضاري والتكنولوجي والفني، وإنما كمان عشان فكرة التحرر القومي نفسها بتفترض إننا كمصريين نقدر نبقى زي أوروبا وأمريكا بنفسنا، والاستعمار مجرد عائق في طريق تحقق الحلم ده. بالتالي فكرة التحرر القومي مابتتضمّنش تفكير نقدي في ضوابط التحرر نفسها، ومابتجاوبش على سؤال بسيط لازم نطرحه في السياق ده: إشمعنى إذا بقينا زي هناك هنبقى كويسين هنا؟
بغض النظر عن الإجابة المباشرة على السؤال، النقطة اللي ممكن تكسر التفكير السائد عن تقدم وتأخر الصناعة المصرية بالمقارنة بالصناعات المركزية واضحة في نوع ثاني من الاطلاع على العالم، المرة دي عن طريق دراسة صناعات برة المراكز الكبيرة، زي صناعة رومانيا وإيران مثلاً. من ستين وسبعين سنة، وقت ازدهار الصناعة التجارية المصرية قبل ظهور القطاع العام، ماكانش فيه صناعات قوية في رومانيا وإيران ولا كان عندهم سينما بديلة منتشرة وممنهجة. بينما السينما الرومانية كانت محتكرة في إيدين الدولة الشيوعية وبتردد تيمات البروباجاندا الرسمية، السينما الإيرانية كانت عبارة عن مجموعة أفلام تجارية معروفة بإسم ال”فيلمفارسي”، وكانت بتقتبس تيمات من صناعات المنطقة زي صناعة بومباي والقاهرة. السنين تلف وتدور، والسينما الرومانية والإيرانية بقت تصدر أفلام جديدة بجماليات جديدة، والمشاكل اللي كانوا بيشتكوا منها مابقتش موجودة بنفس القوة، بينما الصناع المصريين بقوا هم اللي بيشتكوا حالياً من نفس المشاكل.
ده مش معناه إن الصناعة المصرية أو الرومانية أو الإيرانية أو الهوليوودية بطبيعتها متقدمة أو متأخرة، لأن تواريخ الصناعات العالمية دي مالهاش خطوط مستقيمة ولا متوقعة، ولكن معناه إن صناع السينما بيواجهوا مشاكل متشابهة في ظروف تاريخية مختلفة. ورغم إن الحلول اللي بيلاقوها مش دايماً تنفع في ظروف تاريخية ثانية، الصناع ممكن يتعلموا من تجارب أخرى عشان يوصلوا لصناعة السينما اللي هم عايزينها. باختصار، مافيش حتمية في مصير صناعة السينما المصرية ولا تاريخ مصر نفسه، والدليل هي خطوط التطور اللي خدتها الصناعات الرومانية والإيرانية مثلاً، واللي ماكانش حد يتوقعها إطلاقاً من عشرين سنة فقط. فلما نيجي نسأل إشمعنى هناك ومش هنا، لازم كمان نسأل إشمعنى دلوقتي ومش في وقت ثاني.
بالإضافة للجماليات والتقنيات اللي الصناع يقدروا يتعلموها – أو يقتبسوها – من الصناعات الثانية دي، يقدروا كمان يبصوا لنموذج إنتاجها وتوزيعها عشان يعرفوا العوائق المادية اللي قدام تحقق التغيير ده في الصناعة المصرية الحالية. من ناحية التوزيع، فسينمائيين كثير في مصر بقوا يروحوا نفس الأسواق اللي بتتعرض فيها الأفلام الرومانية والإيرانية الجديدة، وهي أسواق المهرجانات العالمية الكبرى المتمركزة في أوروبا بشكل أساسي، ولو إن الأسواق دي مابقتش أوروبية فقط مع ظهور مهرجانات ثانية لها وزن اقتصادي وفني نسبي في كوريا الجنوبية (بوسان) وهونج كونج والإمارات (دبي) على سبيل المثال. ولكن مازال السوق العالمي ده منحصر في دائرة ضيقة ومش سهل الوصول إليها إلا بمجموعة شروط تقدر تجذب عين مبرمجين المهرجانات.
اللي خللى الأفلام الرومانية والإيرانية الجديدة توصل إلى قدر من الاعتراف العالمي مش مجرد جودتها الفنية والتقنية المنفردة، وإنما كمان مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي حددت ذوق المبرمجين وبالتالي نوع الأفلام اللي بتتعرض فيها. كون إن الرومانيين والإيرانيين وصلوا في الدائرة دي مالوش علاقة بهويتهم القومية، وإنما بنوع من الذكاء والشطارة اللي اتبنت عبر سنين من التفاعل مع مبرمجين المهرجانات العالمية عشان يخرّجوا بعض الأفلام الناجحة في الدائرة دي. والجدير بالذكر إن جزء كبير من السينمائيين الرومانيين والإيرانيين اللي اتشهروا في المهرجانات العالمية هم نفسهم عايشين برة بلادهم وشغالين بنمط إنتاج مشترك بين كذا شركة ودولة أوروبية، وده في حد ذاته بيسهل الوصول للمهرجانات العالمية بالمقارنة بأفلام جاية من دول مالهاش واسطة قوية.
نمط الإنتاج والتوزيع ده مش قوي في مصر، وبالتالي بيصعب على السينمائيين اللي عايزين يوصلوا للمهرجانات العالمية إنهم يوصلوا بسهولة. التجارب الفردية زي “الخروج للنهار” لهالة لطفي أو “آخر أيام المدينة” لتامر السعيد أو “ورد مسموم” لأحمد فوزي صالح أو حتى “678” و”اشتباك” لمحمد دياب نابعة من مئات دوسييهات التقديم على المنح والمهرجانات من ناحية، وبعض العلاقات الفردية بين المخرجين والمبرمجين من ناحية ثانية. ولكن من غير مساعدات عضوية بين السينمائيين وبعض، ومن غير وسائط قوية مع المهرجانات الخارجية، السينما المصرية مش ممكن تصدّر أفلام بنفس شكل السينما الرومانية الجديدة أو السينما الإيرانية. وده من غير ما نذكر العوائق اللي بتحطها مؤسسات الدولة المصرية على صناعة السينما، بما في ذلك التصاريح الأمنية اللا متناهية والتمويل الثقافي اللي بيتوزّع بمنطق السوق المحلي مش بمنطق الوصول لأسواق المهرجانات العالمية.
إذن جزء من الرد على سؤال “إشمعنى هناك ومش هنا” له علاقة بالفصل بين نموذج الإنتاج المصري المعتاد وأسواق التوزيع اللي بتخلق السمعة العالمية. الفصل ده مرتبط طبعاً بالجماليات السينمائية المحلية المختلفة، بما في ذلك الجماليات التجارية واللي بتحاول تقتبس الروح الهوليوودية، وهو كمان مرتبط بالعوائق المادية اللي قدام السينمائيين في مصر، سواء كانت في التمويل أو التصاريح أو حتى المساعدات الإدارية البسيطة اللي ممكن تسهّل التقديم للمنح والمهرجانات. في الإطار ده، التعاون المؤسسي سواء كان رسمي أو غير رسمي ممكن يساهم في تطور نوع جديد من السينما، ولكن للأسف، واضح إن المؤسسات الرسمية مابتسندش الإسهامات دي ولا عندها خبرة قوية في الموضوع، والمؤسسات الغير رسمية مش منظمة بما يكفي عشان تبني علاقات إنتاج وتوزيع قوية في الظروف الحالية.
بشكل عملي، العلاقات الجديدة دي ممكن تتبني بين الصناع اللي عندهم صلات قوية بالمهرجانات العالمية، وممكن يحصل تبادل أفكار أحسن وبشكل ممنهج أكثر من العلاقات المشخصنة السائدة في الوسط الحالي. ولكن إذا فكرنا في ظروف أمثل، ممكن نتصوّر إن نموذج الإنتاج والتوزيع الجديد هيكون لصالح ناس ثانيين أكثر من الأفلام في حد ذاتها أو الصناع اللي بيحطوا إسمهم عليها. فمثلاً ممكن نتخيل إن نموذج إنتاج وتوزيع جديد هيخدم جميع العمال اللي شغّالين في الصناعة مش بس المخرجين والممثلين. وعشان نوصل للنقطة دي، لازم نوجّه نقد ممنهج ضد التراتبية الشديدة الموجودة في الصناعة السينمائية السائدة حالياً، وخاصةً الربط بين مرتبات العمال ومركزهم التراتبي جوة الصناعة.
في جميع الأحوال، لازم الصناع يبدأوا يشوفوا خطوط ثانية عشان يطوّروا الصناعة السينمائية المصرية في إتجاهات أوسع حتى من نوع العالمية اللي بتخلقها هوليوود أو المهرجانات السينمائية. الفكرة مش إن صناعة السينما المصرية تبقى زي الصناعة الهوليوودية، ولا إنها تكرر أنماط إنتاج السينما الرومانية أو الإيرانية، وإنما كمان إن الصناع المصريين اللي عايزين سينما غير السينما الموجودة حالياً يفتحوا آفاقهم أبعد من العالمية المركزية أو الثقافية. تغيير الصناعة المصرية هيمر أولاً بتكسير الاعتقاد القومي عن “أصالة” السينما، بما إن السينما فن عالمي من أساسه، وثانياً بتغيير المفردات المادية اللي بتحكم السينما دي والصناع اللي عايزين يتخطوها.
نُشر هذا المقال في مجلة الفيلم، العدد 14، سنة 2018